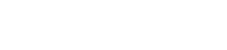مدونات
الثروات المالية للمسؤولين الحكوميين في بريطانيا.. حقوق مشروعة أم علامات استفهام؟
نشر
منذ سنتينفي
1٬065 مشاهدة
By
Fatima
في زمن الرخاء الاقتصادي، كان البريطانيون في شغل شاغل عن التفتيش في التفاصيل المالية والاقتصادية الخاصة والمرتبطة بالمسؤولين الحكوميين، ولم يكن يتصدر مشهد الحديث عن الأثرياء في ذلك الوقت، سوى مشاهير الفنانين ورجال الأعمال ولاعبي كرة القدم أمثال ميسي ورونالدو عندما ينتقلون من نادٍ إلى آخر، لا على سبيل الأمر المهم، وإنما على سبيل التندر والتسلية وإمضاء الوقت.
كتب: محسن حسن
لكن اختلف الأمر اليوم؛ فالحياة البريطانية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي صارت جحيماً لا يطاق من حيث التضخم وغلاء الأسعار ومواجهة متطلبات المعيشة من سكن وفواتير وأزمات متلاحقة في الكهرباء والغاز والتدفئة، ناهيك عن مظاهر الفقر والجوع والتشرد التي جعلت أعداداً غفيرة من البريطانيين يتدفقون على بنوك الطعام التي استغاثت بدورها طالبة المساعدة، بعد أن أوشك مخزونها الاحتياطي من الغذاء على النفاد بفعل تلك الحالة الطارئة التي تشهدها البلاد لأول مرة منذ أربعة عقود، ولذلك فقد أصبح استعراض الثراء الفاحش للمسؤولين الحكوميين وذويهم أمام عموم الجماهير وعلى شاشات التلفاز ليلاً ونهاراً في المملكة المتحدة، أمراً مثيراً للدهشة والتعجب، وداعياً للغضب والسخط، وطرح الأسئلة ووضع علامات الاستفهام!!
وبدورها، ألقت التفاصيل الخاصة بتكلفة حفل تتويج الملك (تشارلز الثالث)، بظلالها القاتمة على نفوس فقراء بريطانيا، وذلك لأن الحفل كلف الخزانة العامة البريطانية ما بين 100 إلى 150 مليون جنيه استرليني، وهي التكلفة التي زادت كثيراً عن تلك التي تكبدتها الخزانة في حفل تتويج مماثل للملكة الراحلة إليزابيث الثانية (حوالي 50 مليون جنيه استرليني)، وشتان بين الفترتين في بريطانيا، هذا إلى جانب تكاليف أخرى على هامش الحفل الملكي التقليدي، منها تكلفة تعطيل الإنتاج في يوم التتويج، والذي كان عطلة رسمية في البلاد كلفت الخزانة ما يزيد على 1.5 مليار جنيه استرليني، الأمر الذي أثار حفيظة الجميع في البلاد، وخاصة من ذوي الدخل المحدود، والذين باتوا يتساءلون بين بعضهم البعض، ويطرحون سؤالاً متكرراً هو: هل يشعر ملكنا المتوج ومعه باقي مسؤولينا الحكوميين بحجم ما نعانيه من أزمات اقتصادية وتراجع حاد في المعيشة؟ ثم لا تلبث الإجابات المتناقضة أن تنهال عليهم من كل حدب وصوب، تارة تذكرهم بمنطقية الفوارق المادية والطبقية بين البشر، وتارة أخرى تحاول إقناعهم بجدوى ثراء الشخصيات العامة والحكومية في الحفاظ على هيبة الحكم وسيادة الدولة، وتارة ثالثة تصدمهم بالحقائق التي لا تستوعبها أو تتقبلها عقولهم؛ مثل كيفية قبولهم بعكس ما يؤكده القول المأثور (فاقد الشيء لا يعطيه)، وهل يمكن لأصحاب الثراء الفاحش الذين يتنعمون بما لديهم من أموال طائلة، ليل نهار، أن يشعروا على وجه الحقيقة والواقع بنفس ما يشعر به عامة الفقراء والمحتاجين من حولهم؟ وماذا إذا كان أصحاب الثراء هم أصحاب القرار والحكم، هل بإمكانهم تحييد شعورهم بالثراء والغنى، ليدركوا حجم المعاناة والتحديات التي تحيط بمن يحكمونهم ويتحكمون في تسيير شؤونهم من عامة الشعب؟ إنها الأسئلة والأسئلة والأسئلة، تطرح نفسها مراراً وتكراراً على أذهان البريطانيين، ولكنها في كل مرة لا تعود إليهم بردود وإجابات سارة أو شافية، وإنما تزيدهم إيماناً وقناعة كلما مر الوقت وتتابعت الأيام والشهور والسنوات، بأن الحكام والمسؤولين بالمملكة المتحدة في واد، والمحكومين من الشعب في واد آخر تماماً!!
وتلك الصدمة التي سببتها تفاصيل حفل التتويج الملكي بتكلفته الباهظة والمبالغ فيها، لم تتشكل لدى الذهنية البريطانية من فراغ، وإنما ساهم في تغذية المشاعر السلبية تجاهها، تاريخ طويل من الغموض المحيط بالشؤون المالية للقصر الملكي، وخاصة في عهد الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، والتي رغم عدم تدخلها السافر في عموم السياسة البريطانية من الناحية السياسية، إلا أنها فرضت سياجاً من التكتم والسرية على كافة الأمور المتعلقة بالتفاصيل الداخلية لذلك القصر، وهو ما جعل الشعب البريطاني لسنوات طويلة بمعزل عن كل المعلومات الرئيسية المرتبطة بنظام الملكية البريطاني، وخاصة ما يتعلق بالنفقات الخاصة بالقصر، وهذه السرية المفروضة كانت سبباً في استفزاز الصحافة البريطانية لسنوات طويلة ماضية وإلى الآن، وتحريها المستمر للحصول على تلك المعلومات بطريق أو بأخرى، حتى أن العام 2021، وقبل رحيل الملكة، شهد الكشف عن بعض الأوراق الرسمية التي تثبت إساءة استخدامها أكثر من مرة، هي ومستشاريها، توظيف ولي العهد في تغيير بعض القوانين البريطانية سراً، مثال ما حدث عام 1973، عندما قامت بذلك من أجل فرض المزيد من السرية حول مقدار الثروة المالية الملكية، وفي كل الأحوال، كانت السرية الصارمة للملكة الراحلة، تمنع من الاطلاع على تفاصيل المراسلات الخاصة بها أو بولي العهد، وتقضي بحظر أي انتقاد رسمي أو حزبي أو برلماني للسلوكيات الشخصية المعلنة وغير المعلنة لأفراد العائلة المالكة، مهما كانت معيبة أو مشينة، وحتى الوثائق الملكية الخاصة بتاريخ بريطانيا الملكي والدستوري، والتي يُفترض إتاحتها للباحثين والدراسين، تحكم (آل وندسور) في منح الموافقات المتعلقة بالاطلاع عليها أو فحصها، كما اقتضى النظام الصارم للملكة، خضوع الثروات المالية الخاصة بالعائلة الملكية لرقابتها الخاصة ووفق صيغ قضائية، حفاظاً على تلك الثروة من تطفل العامة من الشعب البريطاني، وكإجراء احترازي، لم يسمح القصر الملكي منذ عام 1967 بتعيين المهاجرين الملونين أو الأجانب في الوظائف الكتابية، ويبدو أن أعضاء الحكومة البريطانية في الماضي وحتى اللحظة، متوافقون مع السرية المالية والثرواتية للقصر الملكي، وهو ما يتضح حتماً من ردودهم التاريخية والراهنة على بعض المطالب الهادفة إلى الكشف عن حجم النفقات المالية المرتبطة بتكلفة الحماية الشخصية والأمنية لساكني القصر الملكي، حيث يكون الرد دوماً هو الرفض بحجة أن الكشف عن مثل هذه التفاصيل من شأنه تعريض سلامة الملك وباقي أفراد العائلة للخطر.
وقد أدى انشغال الساحة البريطانية مؤخراً، بالعديد من قضايا الفساد المالي والإداري المخلوط والمعجون بماء السياسة والسلطة والنفوذ، إلى تغذية المشاعر السلبية لعموم البريطانيين تجاه هذه الحالة المزمنة من استعراض الثراء؛ فعلى مدار سنوات متتالية، لم تتنازل داونينج ستريت عن إثارة البلبلة والامتعاض والنقد اللاذع المرتبط بالمال والثراء الغامض في نفوس الشعب، وفي وقت يعاني فيه الجميع من حالة اقتصادية متردية تشمل كافة القطاعات والشرائح الاجتماعية؛ فبنظرة عابرة وسريعة، سنجد أن الكثير من أعضاء البرلمان في المملكة المتحدة، يمتلكون وذويهم ثروات هائلة وضخمة، تثير الكثير من الشكوك حول مصدرها وحول بعدها أو قربها من شبهات الفساد المنتشرة في دوائر صنع القرار داخل الحكومة البريطانية، خاصة في ظل التحديات والصعوبات الاقتصادية الراهنة. وفي هذا السياق، نستطيع القول إن أصحاب هذه الثروات، هم الذين يثيرون الريبة والشك في نفوس من حولهم من المواطنين والأقران على السواء، كما أن قضايا الفساد المعلنة في البلاد والتي أطاحت ببعض الشخصيات بعيداً عن دائرة الضوء، هي الأخرى تثير المزيد من تلك الشكوك، وبالطبع يعرف الجميع في المملكة المتحدة أن الثراء والغنى ليس عيباً أو جريمة في حد ذاته، ولكنهم من جهة أخرى، يدركون تماماً أن اجتماع الثراء والنفوذ الحكومي والسياسي، كثيراً ما يورط صاحبه في تجارب هي أبعد ما تكون عن مراعاة العدالة والنزاهة والقيام بواجبات المنصب كما ينبغي أن يكون، ولذلك فقد أصبحت السنوات الأخيرة تشهد متابعة دقيقة من قبل الشعب البريطاني لكافة السلوكيات الصادرة عن المسؤولين الرسميين، وكذلك لكافة القضايا المثارة في المحاكم وأروقة القضاء، وأيضاً للشخصيات التي تشغل المنصب الحكومي الأعلى في الحكومة البريطانية، أي منصب رئيس الوزراء.
فعلى مستوى هذا المنصب الأعلى، سنجد أن التقارير المتداولة بخصوص الرئيس الحالي (ريشي سوناك) على سبيل المثال، تشير إلى أنه كان ناجحاً كرجل أعمال قبل أن ينخرط في العمل السياسي عام 2015، وأنه كان يعد مليونيرا وهو في العشرين من عمره، مكنته مواهبه المالية من جني الكثير من المال، وأنه بعد انخراطه السياسي وعمله كمستشار كان يتقاضى راتباً سنوياً يزيد على 150 ألف جنيه استرليني، وأنه كان في بداياته السياسية من أغنى أعضاء مجلس العموم البريطاني، كما أنه ذو عائلة ثرية تمتلك من العقارات ما يقدر بملايير الجنيهات الاسترلينية من لندن إلى كاليفورنيا، ولكنه رغم كل هذا، صدّر نفسه كشخصية ثرية متعالية على القيم والقوانين البريطانية، كما أن زوجته (أكشاتا موراتي) التي تفوق ثروتها ما كانت تملكه إليزابيث الثانية ملكة بريطانية الراحلة، أساءت كذلك التعامل مع تلك القيم والقوانين، وذلك عندما تغاضت عن أداء الضرائب المستحقة عن ثروتها عبر ثغرة كونها غير مسجلة كمقيمة، في الوقت الذي لم يسمح فيه زوجها عبر منصبه الرسمي، سوى برفع الضمان الاجتماعي الشامل بنسبة هزيلة لا تتجاوز 3%، وهي النسبة التي لا يستطيع معها المواطن البريطاني مواجهة التضخم البالغ وقتها 8% (أكثر من 10.5% حالياً)، وقد ترتب على هذا المظهر المزدوج والمنتقد، أن تعرض (سوناك) وعائلته لانتقادات حادة من قبل الشؤون الضريبية في البلاد، الأمر الذي وضع منصب رئاسة الوزراء في موضع النقد المشوب بالريبة والشك، خاصة مع التراخي الذي شهدته الحكومة تجاه ملف الفساد المالي في البلاد، والذي أثار تساؤلات حادة وجماهيرية بشأن الثروات الشخصية الهائلة التي يمتلكها بعض النواب البرلمانيين في حزبي المحافظين والعمال على السواء.
وقبل ريشي سوناك، أفادت بعض المؤشرات الخاصة بأحد شاغلي المنصب قبله، وهو (بوريس جونسون) بأنه كان يتقاضى سنوياً قرابة الــ 170 ألف جنيه استرليني كراتب، وبأنه يمتلك هو وزوجته(كاري جونسون) مسكناً في لندن يقدر ثمنه بأكثر من 1.5 مليون جنيه استرليني، إلى جانب امتلاكه حصة في عقار عائلته نسبتها 20%، كما تشير المؤشرات ذاتها إلى حصول جونسون على أموال طائلة، ما كان يمكن أن يحصل عليها لولا وجوده في منصبه كرئيس للوزراء، ومن هذه الأموال مثلاً ما كان يتعلق بمقابلاته الصحفية والتليفزيونية، والتي تشير بعض التقارير بشأنها، إلى أنه حصل على أكثر من 400 ألف جنيه استرليني نظير ثمانية من تلك المقابلات فقط، حيث كانت تقدر الساعة الواحدة له بحوالي 20 ألف جنيه استرليني، بل ربما حصل على أكثر من ذلك في بعض الأحيان، كما حدث عندما ألقى خطاباً حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في فندق تاج بالاس في نيودلهي بالهند، حيث حصل على أكثر من 120 ألف جنيه استرليني، كما كان يحصل على أكثر من 270 ألف جنيه استرليني لقاء قيامه بكتابة عمود أسبوعي لإحدى الصحف.
وبعيداً عن منصب رئاسة الوزراء، هناك العديد من المسؤولين الحكوميين والوزراء والبرلمانيين، ممن يملكون أموالاً طائلة تم تحقيق جزء كبير منها أثناء تواجدهم في مناصبهم؛ أحد هؤلاء قام بمشاركة زوجته بإنشاء شركات تمكنت من تدشين محفظة عقارية بقيمة 100 مليون جنيه استرليني، تم شراء نصفها خلال عمله الوزاري، وهي عبارة عن قصور واسطبلات ريفية ومنازل وعقارات في شوارع لندن الرئيسية وفي دبي، وأحد هذه القصور تم شراؤه بأكثر من 850 ألف جنيه استرليني عبر شركات وسيطة.
وبخلاف هذا هناك شخصية كبيرة أخرى، استطاع خلال منصبه في اسكتلندا من تكوين ثروة تزيد على 19 مليون جنيه استرليني بواسطة تأسيس شركات عاملة في تخزين الخيام وتأجيرها، وهو حالياً يستحوذ على ملكية 1200 فدان عبارة عن مزرعة بالقرب من لوكيربي، وسبق له الإعلان عن ملكية العديد من الأسهم في أكثر من 15 شركة، تبلغ قيمة أسهمه في 10 شركات منها فقط ما يزيد على 65 ألف جنيه استرليني، وما يثير الريبة والشك بخصوص هذه الأسهم، أن بعضها ينتسب لتكتل صناعي مدرج في بورصة لندن، تم تأسيسه بداية عام 1984 في منطقة برمودا البريطانية، والتي تصنف على أنها أسوأ مناطق الملاذات الضريبية للشركات ضمن 15 ملاذاً ضريبياً على مستوى العالم. شخصية برلمانية أخرى كانت تلعب دوراً محورياً في الخطوات الإجرائية المتعلقة بالخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، وهو المنصب الذي قوبل بانتقادات حادة من شخصيات ذات حيثية كبيرة في منظمة الشفافية الدولية، نظراً لإمكانية استغلاله وتوظيفه لتحقيق ثروات شخصية، ويبدو أن الانتقادات كانت محقة، فعبر إحدى الشركات التي قام هذا البرلماني بتأسيسها عام 2007، استطاع الحصول منفرداً على أرباح طائلة بحلول عام 2020، قدرت بأكثر من 750 ألف جنيه استرليني، من جملة أرباح حققتها الشركة قاربت الــ 15 مليون جنيه استرليني، وحالياً يتمتع هذا البرلماني بحياة ثرية وبممتلكات تاريخية من بينها قصر مصنف من الدرجة الثانية يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر، بالإضافة إلى عقار آخر بقيمة تفوق الــ 6 ملايين جنيه استرليني، وممتلكات كثيرة أخرى. والقائمة في هذا السياق تطول وتطول كثيراً!! ويبدو أن القوانين البريطانية بها عوار كبير في حماية أموال وموارد الدولة من الاستنزاف والتملك عبر استغلال المناصب وتوظيف النفوذ السياسي والبرلماني والحكومي، وليس أدل على ذلك من أن تلك القوانين تسمح للكثير من الأثرياء سواء من ذوي المناصب السياسية أو من غيرها، بالتحايل على التشريعات الضريبية، لتجنب أداء الحصة المقررة على الأرصدة والثروات، وقد حدث أن أحد وزراء الصحة الذي تقدر ثروته بأكثر من سبعة ملايين جنيه استرليني، استطاع خلال مسيرته المصرفية ولمدة ست سنوات كاملة كان يتقاضى خلالها راتباً سنوياً قدره ثلاثة ملايين جنيه استرليني، أن يحصل على صفة (غير مقيم)، وهو ما مكنه من تجنب دفع الضرائب الخاصة بالأرباح الخارجية خلال كل تلك المدة!!
وفي حقيقة الأمرـ، فإن قضية الثروات المالية للمسؤولين الحكوميين في بريطانيا، لا يمكن أن تختزل في مجرد وجود خلل ما في حماية المال العام من السرقة والاستنزاف واستغلال النفوذ والمنصب؛ لأن القضية أكبر من ذلك بكثير، وهي تتعلق بمدى قدرة المملكة المتحدة حالاً ومستقبلاًـ، على صياغة نظامها السياسي صياغة أخلاقية، يمكن من خلالها بناء جيل من المسؤولين الحكوميين المنتمين إلى طبقة العمال والمهنيين والنقابيين، بدلاً من تضييق الخناق عليهم، والسماح فقط لطبقة الأثرياء بشغل المناصب السياسية والحزبية والبرلمانية، بشكل يصعب معه التقارب الحقيقي بين تلك الطبقة الثرية، وباقي الطبقات والشرائح الاجتماعية الأقل ثراءاً واستحواذاً على المناصب والأموال، ولقد بات واضحاً عمق هذه الفجوة خلال اندلاع المظاهرات النقابية والمهنية والوظيفية الأخيرة في بريطانيا؛ ففي الوقت الذي تهاونت فيه رئاسة الوزراء مع شخصيات فاسدة ومتنفذة ومستغلة لمناصبها الحكومية والبرلمانية والحزبية لتحقيق الثراء الفاحش والحصول على الأموال الطائلة بغير حق، فإنها ظلت تماطل وتماطل وتماطل بشأن منح زيادات مالية متواضعة ومنطقية لطبقة المهنيين والعمال ومحدودي الدخل، ومثل هذا السلوك الحكومي الرسمي، هو من تبعات ونتائج وتداعيات الخلل الطبقي القائم والحاضر في النظام السياسي البريطاني، المرتكز إلى تشريف الأثرياء والحط من قدر الفقراء، وبشيء من التدقيق والبحث، يمكننا العثور على نماذج حية ومظاهر واقعية تصلح للتدليل على طبيعة هذا الخلل، ويمكن تلخيصها وتكثيفها في جملة الملامح والأحداث التالية:
* في ظل موجات التضخم القياسية ومعاناة البريطانيين اليومية، ورفض الحكومة الاستجابة لمطالب المتظاهرين بزيادة رواتبهم، يصطدم المواطن البريطاني بقرار صادر عن رئاسة هيئة المعايير البرلمانية المستقلة، بزيادة رواتب الأعضاء البرلمانيين اعتباراً من أبريل الماضي 2023 بمقدار 2440 جنيهاً استرلينياً، وكأن الأثرياء يصبون في جيوب الأثرياء، أو يتخذون قرارات الثراء بأنفسهم ولأنفسهم، بمعزل عن بقية الطبقات.
* عندما نتأمل الخطاب الإعلامي والبرلماني والحزبي لطبقة الأثرياء الحكوميين، نجدهم يبدون أسفهم الشديد وحزنهم الكبير تجاه معاناة الطبقات الفقيرة والأشد فقراً، ولكنهم من جهة أخرى يديرون نظاماً مهووساً بالثروة، لا يتورع مطلقاً عن تجريد تلك الطبقات من إنسانيتها، والتعبير عنها باعتبارها مجرد إحصاءات اقتصادية في سلم الأولويات الحكومية.
* في هذا المجتمع البريطاني الذي يصل فيه الأثرياء إلى أعلى المناصب بالسرعة القصوى، ويعاني فيه الفقراء من تحديات معجزة تمنعهم من الوصول لذات المناصب، لا يمكنك إلا أن تسلم باتساع متنام للطبقية الاجتماعية والفوارق المعيشية؛ ففي حين يظل كثيرون محاصرين بالفقر محرومين من الرخاء والازدهار، يظل كذلك الذين يديرون النظام من الأثرياء، محاصرين بالثروة متلذذين بالهيمنة.
* من مظاهر البعد الأخلاقي المفتقد في مراعاة التنوع الطبقي الشامل داخل بنية المسؤولين الحكوميين في مجلس الوزراء البريطاني، أنك تلمح تنوعاً في الثقافات والمهارات والأجناس، لكنك لا تجد تنوعاً في الخلفيات المالية والوظيفية، رغم أنها تؤدي نفس أدوار التنوع الأخرى في تعريف المواطنين بالقادة السياسيين، كما أن من مظاهر ذلك البعد أيضاً، عدم شيوع نمط المسؤول الحكومي المهيأ بسمات أخلاقية تمنحه القدرة على تحمل التضحيات والمخاطر الشخصية في سبيل تحقيق المصالح الوطنية للطبقات الاجتماعية الأدنى من طبقته.
وختاماً، نحن هنا، لسنا بالطبع، بصدد الهجوم على الأثرياء أو أصحاب المال من السياسيين والحزبيين والبرلمانيين، فهم في كل الأحوال أناس وصلوا إلى مناصبهم وفق اختيار الناخبين، وهم يؤدون واجباتهم ومهماتهم التي كلفوا بها بقدر ما يستطيعون، كما أننا لسنا هنا بصدد التشكيك في الذمة المالية لأعضاء ومسؤولي الحكومة البريطانية والعناصر الحزبية والبرلمانية، فهذا من صميم عملنا، وإنما من صميم اختصاص الأجهزة الرقابية والقضائية، كما أننا لسنا بصدد المناداة بحرمان المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، من حقوقهم الطبيعية والأخلاقية والإنسانية في امتلاك وجمع الملايين والملايير بالطرق الأخلاقية المشروعة، فهذا ليس هدفنا ولا مقصدنا، نحن فقط نريد أن نلفت النظر إلى مخاطر اتساع الهوة والفجوة بين الطبقات في بريطانيا، وإلى ضرورة وقف المد الطبقي الغالب والمهيمن على إسناد المهام السياسية والحزبية والبرلمانية للأغنياء دون الفقراء، وترسيخ هذا المفهوم داخل بنية الممارسة السياسية للناخب البريطاني، بشكل يتعود معه هذا الناخب على الانتماء لذوي الثراء اختياراً وتشريفاً، والنفور من ذوي الدخل المحدود استبعاداً وتحقيراً؛ لأن مثل هذا التأطير السياسي المراد به تمكين الأثرياء من الاستحواذ على المناصب، يفرز في الغالب طبقة من الانتهازيين المنكبين على منح جل أوقاتهم وخبراتهم لمصالحهم الشخصية والمالية والثرواتية، مقابل منح القليل من الوقت والخبرة والجهد لتحقيق مصالح الجماهير، وليس أدل على مخاطر هذا التأطير في المجتمع البريطاني حالياً، من أن أكثر الناس ثراءاً وغنى وسلطة، هم من يقومون باتخاذ القرارات الحياتية والمصيرية لأكثر وأشد الطبقات فقراً واحتياجاً.. إنها معادلة غير عادلة، وتحتاج إلى إصلاح سياسي وتعديل تنظيمي وأخلاقي ننتظر أن يحدث يوماً ما في بنية المسار المستقبلي للسياسة البريطانية.

بريطانيا تنجو بنسبة 50% من رسوم ترامب على الصلب

موجة الحر تضرب بريطانيا.. وتحذيرات بإغلاق النوافذ لمدة يومين!

مستشفى نوتنغهام متهم بالقتل غير العمد، هل هذا صحيح؟

سباق جزيرة مان تي Man T في المملكة المتحدة

الخرافات الرياضية التي يؤمن بها لاعبو كرة القدم: وهم أم حقيقة!

ستة تغييرات مالية كبرى في يونيو 2025 قد تؤثر على ميزانيتك.. إليك ما هي؟

وعود برحلات أسرع في المملكة المتحدة

قنبلة تنهي حفل جوائز المسلسلات البريطانية بطريقة مرعبة

نادي بيراميدز: ورحلة الصعود إلى المجد القاري، ماهي القصة خلف هذا النجاح!