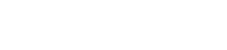مقالات
المهاجرون وكنوز بريطانيا الكامنة.. متى تنتبه داونينج ستريت لتجليات النموذج الأوغندي؟
نشر
منذ سنتينفي
734 مشاهدة
By
Baida
في كثير من الأحيان، يميل المسؤولون السياسيون إلى تفضيل الحلول السريعة والعاجلة لمشكلات بلادهم الاقتصادية، في حين يتباطؤون عن المضي قدماً في اعتماد خطط الإصلاح المستدامة التي تتطلب المرور بالعديد من مراحل الإصلاح والمتابعة والتدقيق والدعم، إلى غير ذلك من الإجراءات الإصلاحية التي قد لا تتناسب ورغبة السياسي الملحة في إظهار إيجابيات قيادته وشغله للمنصب الحكومي عبر تحقيق إنجازات عاجلة وسريعة تعزز هذه القيادة أمام الجماهير، وتسكت ألسنة المنافسين السياسيين والحزبيين.
وللأسف الشديد، يفضي هذا الميل في النهاية إلى تحقيق مكاسب شخصية ومصالح مالية واستثمارية للمسؤولين الحكوميين، مقابل حرمان الاقتصاد الوطني من إصلاح القطاعات الحيوية، وبقاء المشكلات الأساسية في الجوانب المعيشية على مستوى الأجور والرعاية الاجتماعية والصحية والخدماتية على حالها دون علاج أو إصلاح، وهذا يحدث بكل تفاصيله في دول عديدة على مستوى العالم، من بينها بريطانيا.
كتب: محسن حسن
وينطبق الطرح السابق، على نظرة المسؤولين السياسيين في بريطانيا لمشكلة المهاجرين بصفة عامة، ومشكلة المهاجرين غير الشرعيين بصفة خاصة؛ حيث لم يكن مطروحاً أبداً أمام الحكومات المتعاقبة في داونينج ستريت، إمكانية توظيف القوة البشرية الهائلة لهؤلاء المهاجرين، في خدمة الاقتصاد البريطاني، رغم أن سوق العمل في المملكة المتحدة يئن تحت وطأة النقص الحاد في العمالة اللازمة للتشغيل والإدارة والإنتاج إلى الدرجة التي اضطرت معها الحكومة ــ بحسب إفادات معهد دراسات التوظيف ــ إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات في مارس الماضي 2023 لتشجيع الآباء والمتقاعدين وذوي الإعاقة أو الذين يعانون من حالة صحية سيئة، على العودة إلى العمل؛ فرغم ما ذكره مكتب الإحصاء الوطني في البلاد، من أن التوظيف في بريطانيا سجل رقما قياسيا تجاوز 33 مليون موظف/وظيفة بين شهري فبراير وأبريل الماضيين، إلا أن المؤشرات الرسمية المعلنة من قبل المكتب، تؤكد معاناة الاقتصاد المحلي من نقص قوامه مليون عامل، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأجور وجعل مشكلة التضخم في بريطانيا أكثر صعوبة في الحل.
وبشيء من التدقيق والملاحظة، سنجد أن نقص العمالة جعل متوسط الأجور العادية، باستثناء المكافآت، يرتفع بنسبة 7.2٪ خلال الربع من فبراير إلى أبريل مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وهو الارتفاع الأسرع على الإطلاق في بريطانيا منذ فترة ارتفاعات جائحة كوفيد19، وفق ما أكده مسؤولون في دائرة الإحصاءات الاقتصادية بمكتب الإحصاء الوطني، وهذا سيؤدي بدوره إلى زيادة مخاوف بنك إنجلترا حالاً ومستقبلاً بشأن التضخم المتأصل في الاقتصاد، والذي يراهن المستثمرون الآن على أن مشكلته العنيدة في المملكة المتحدة ستؤدي إلى زيادة جديدة في تكاليف الاقتراض، كما يُتوقع أن يقوم البنك مجدداً برفع أسعار الفائدة من 4.5٪ لتصل إلى 5.25٪ خلال فترة وشيكة، علماً أن أسعار المستهلك في البلاد ارتفعت بنسبة 8.7٪ في أبريل 2023 مقارنة بالعام الماضي، وهي نسبة تتجاوز التضخم في أوروبا والولايات المتحدة، ومن ثم فإن الأسر الفقيرة تضررت بشدة، وخاصة في ظل بلوغ أسعار الغذاء حداً تضخمياً يفوق نسبة 19٪.
والنتيجة الكارثية المتحصلة من ظاهرة نقص العمالة هي تركيع الاقتصاد البريطاني عبر تقليص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 1.6 ٪ بحلول عام 2027.
وإذا عرفنا أن نقص العمالة يساهم في كل هذه التداعيات الكارثية التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني والسكان في بريطانيا، فسنعرف إلى أي حد يتوجب على الحكومة أن تفكر بجدية في إيجاد صيغة جديدة ومنتجة يمكن من خلالها الاستفادة من أعداد المهاجرين بدلاً من إنفاق المزيد من الأموال على اتفاقيات تنظيم إعادتهم لدول ومناطق مجاورة، خاصة مع وجود قطاعات إنتاج حيوية يمكنها احتواء الكثير من هؤلاء المهاجرين لسد فجوة نقص العمالة، وعلى وجه التحديد قطاعات البناء والزراعة والتجزئة؛ فلا يزال هناك فائض كبير من الوظائف الشاغرة في هذه القطاعات وفي غيرها، إلى جانب وجود سبب وجيه آخر يدفع باتجاه البحث عن حلول لسد نقص العمالة، وهو ازدياد حدة الاعتلال الصحي لدى شرائح الموظفين والعمال وكبار السن في بريطانيا، الأمر الذي يهدد باتساع الفجوة المتعلقة بالوظائف الشاغرة في البلاد؛ إذ تؤكد الإحصاءات الحديثة والمؤكدة أن عدد العمال والموظفين المتوقفين عن العمل بسبب الأمراض طويلة الأمد، قد يصل إلى ثلاثة ملايين بريطاني.
ومن جهة أخرى، يشير العديد من التحليلات إلى أهمية المهاجرين الاقتصادية بالنسبة لبريطانيا؛ فعلى سبيل المثال، تؤكد وزارة الداخلية البريطانية على أن المملكة المتحدة في حاجة ماسة إلى 150 ألف مهاجر على الأقل سنوياً خلال العشرين عاماً المقبلة لسد ثغرات النقص في العمالة، ووفق أحد التقارير الصادرة عن هذه الوزارة، فإن سكان بريطانيا المولودين في الخارج، والبالغ عددهم 5 ملايين مهاجر، يساهمون بنحو 2.5 مليار يورو سنويًا في الضرائب، قياساً بما يتلقونه من الخدمات، وهو دليل على الفائدة الاقتصادية للسكان المهاجرين، وهي الفائدة التي تؤكدها المنظمات التجارية البريطانية ومعها هيئات أخرى بريطانية كهيئة الخدمات الصحية مثلاً، بالإضافة لتجارب صناعية سابقة أثبتت فاعلية العمالة المهاجرة في دعم الاقتصاد والصناعة الوطنية، من ذلك مثلاً صناعة النسيج البريطانية في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، عندما استقطبت أعداد كبيرة من العمال الآسيوين لتحقيق تنافسية عالمية في هذه الصناعة، وإلى جانب كل ذلكـ هناك مؤشرات أخرى ديموغرافية تؤكد حاجة بريطانيا للمهاجرين، حيث أشارت توقعات الأمم المتحدة مؤخراً، إلى أنه لكي تمنع بريطانيا متوسط عمر سكانها من الارتفاع، فإنها ستحتاج إلى مليون مهاجر سنويًا.
ومن الغريب حقاً، أن أهمية المهاجرين الاقتصادية بالنسبة لبريطانيا، يدركها عموم البريطانيين جيداً على المستوى الشعبي والجماهيري، باستثناء الطبقة السياسية والبرلمانية، هي الوحيدة في البلاد التي اتخذت على مدار عقدين ماضيين وإلى الآن، من حركة الهجرة إلى بريطانيا، ذريعة للتنصل من تحقيق الوعود الانتخابية، ولتبرير الفشل في إدارة الاقتصاد الوطني، وبشيء من التدقيق سنجد أن الاتجاه الشعبي في النظر إلى الهجرة كمشكلة بدأ في التراجع تماماً خلال السنوات العشر الماضية، حيث يرى المواطن البريطاني أن الهجرة أحد الموارد المربحة للجميع على المستوى الاقتصادي والثقافي، وأنها محفزة لإنعاش حركة المال والاستثمار، ومصدر حيوي من مصادر دعم الخدمات العامة، وأنه يجب زيادة إلحاق المهاجرين بكافة القطاعات الاقتصادية كالزراعة والصناعة وغيرها.
وما يراه المواطن البريطاني هذا، هو أحد نتاجات التحول الإيجابي الدالة على انحسار نظرات التشكيك التي كانت سائدة قديماً تجاه الهجرة والمهاجرين، وربما ساهمت عدة أسباب أخرى في حدوث هذا التحول، لعل من أهمها إلى جانب الخروج من الاتحاد الأوروبي، تفاني العمال المهاجرين في إتقان عملهم الخدمي والاجتماعي والصحي بين البريطانيين خلال فترة جائحة كوفيد19، وهي الأعمال والجهود التي كانت على قدر كبير من الحيوية والخطورة.
وفي الواقع، فإن الموقف الحكومي الرسمي من قضية الهجرة والمهاجرين، أصبحت محل انتقاد جماهيري شديد في بريطانيا، حتى بعد الانخراط مؤخراً في عمليات إعادة اللاجئين إلى رواندا، بما في ذلك موقف حزبى العمال والمحافظين، رغم أن الأول كان يعد هو الحزب الأكثر مثالية من حيث التعاطي مع هذه القضية، إلا أن فقدان ثقة رجل الشارع والناخب البريطاني في هذين الحزبين، كشفت مدى التوظيف السياسي الممقوت لقضية الهجرة، وباتت تصب في إطار البحث والتفتيش عن تصعيد طبقة جديدة من السياسيين المنفتحين على الترحيب بالمهاجرين وبذل الجهود الصادقة لاحتوائهم ودمجهم ورفع كفاءاتهم ومهاراتهم المهنية والوظيفية والإنتاجية، إلى جانب إنشاء نظام أكثر شفافية وأبعد عن البيروقراطية، يساعد اللاجئين والمهاجرين على الاندماج الكامل والفاعل في المجتمع والاقتصاد.
وهذه التطلعات الجماهيرية الجديدة بين البريطانيين، تستحضر إلى الذهن بعض النماذج والتجارب الدولية الرائدة وغير التقليدية في دمج واحتواء اللاجئين والمهاجرين، وعلى رأسها، النموذج الأوغندي، والذي قدم للعالم تجربة فريدة وناجحة يجب أن تحتذى وتصبح مصدراً من مصادر التعاطي الإنساني والاقتصادي الشامل مع حركات الهجرة واللجوء.. فماذا فعلت أوغندا؟ المسألة باختصار، هي أن أوغندا قامت عام 1958 بتشييد وبناء (مخيم ناكيفيل) بغرض إيواء عدد كبير من اللاجئين التابعين لقبائل (التوتسي)، والذين فروا إلى العاصمة الأوغندية (كمبالا) هرباً من اعتداءات مواطنيهم من قبائل (الهوتو) إثر اندلاع الحرب الأهلية في رواندا، وبمرور الوقت تكررت في المحيط الأوغندي بعض الاضطرابات والحروب الأهلية، وهو ما دفعها لتكرار استضافتها للفارين والهاربين، الأمر الذي تمخض عام 2006، عن قيامها بإصدار قانون ثابت وشامل واستثماري لاستضافة اللاجئين، وهو القانون الذي بمقتضاه يستطيع اللاجئ أن يحصل من الحكومة الأوغندية على كافة الحقوق والخدمات المكفولة للمواطن الأوغندي، كما يستطيع التنقل عبر المدن والمناطق المحلية دون أية عوائق، ومن ثم، فقد استطاعت أوغندا عبر هذا القانون، إنشاء مجموعة متكاملة من مستوطنات اللاجئين، وتوزيعها عبر تسع مقاطعات بطول البلاد وعرضها، استضافت خلالها أكثر من 500 ألف لاجئ قدموا إليها من 15 بلداً إفريقيا، محققة لهم الحماية والأمن والاستقرار والحرية، وهو ما مهد بعد ذلك، وتحديداً بين عامي 2015-2016، لقيام الحكومة الأوغندية بتوطين قرابة الــ 700 ألف لاجئ ممن ينتمون لعدة دول مجاورة تشهد اضطرابات وصراعات عرقية مثل الكونغو والصومال ورواندا وجنوب السودان.
وبالنظر إلى هذا النموذج الأوغندي لتوطين اللاجئين والمهاجرين، سنجد أن الدولة وظفت كل طاقاتها وإمكاناتها لتحقيق هدفين أساسيين وضرورين؛ الأول: منح الوافدين وطناً بديلاً آمناً وكامل الأركان من ناحية الحقوق والواجبات، والثاني: استثمار وجود اللاجئين والمهاجرين فوق الأراضي الأوغندية بشكل إيجابي أقرب إلى الشراكة الاقتصادية؛ فعلى سبيل المثال، جهزت الحكومة الأوغندية كافة مستوطنات اللاجئين بالمرافق اللازمة للعمل والإنتاج، وراعت العوامل النفسية والإنسانية للمهاجرين بشكل غير مسبوق، فكانت تلك المستوطنات تشغل مساحات كبيرة من الأراضي المفتوحة والخصبة، وقد كان مخيم ناكيفيل مثلاً على مساحة تزيد على 200 كيلومتر مربع، وتتخلله تلال وأنهار ويحتوي على مزارع حيوانية وأراض مزروعة من قبل اللاجئين يستمدون منها أغذيتهم، ويقومون بتصدير المحاصيل الفائضة عن حاجتهم إلى الخارج.
وبالإضافة إلى ذلك، لم تغفل الحكومة إمداد مقاطعات اللجوء بوسائل التثقيف والترفيه والتعلم، فكان اللاجئون يتمتعون بوجود الأسواق والعروض السينمائية ووسائل الاتصال الحديثة كشبكات المحمول، إلى جانب توفير مؤسسات التدريب المهني والتقني، وتوظيف المتخرجين منها في قطاع الأعمال الأوغندي، بل عقدت أوغندا شراكات تعليمية ومهنية مخصوصة لتأهيل اللاجئين لسوق العمل، ففي معسكر(أدجوماني) مثلاً، تم تدريب أكثرمن 400 ألف لاجيء من جنوب السودان في مركز(نيومانزي) المهني والخاضع لإشراف مجلس اللاجئين النرويجي، كما تم منح العديد من اللاجئين قطعاً من أراضي البناء لتشييد منازل ومزارع أسرية خاصة تعينهم على الشعور بالاستقلالية الاجتماعية والاقتصادية، وتم تسهيل ربطهم بمؤسسات التمويل والإقراض.
وهذه الجهود الأوغندية المخلصة والإنسانية في التعامل مع المهاجرين والفارين من ويلات الحروب والصراعات العرقية والأهلية، لفتت أنظار (جامعة أكسفورد) البريطانية، وتحديداً فريق (مشروع الابتكار الإنساني)، والذي قام بزيارة تلك المستوطنات عام 2014، وتفقد عموم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي يباشرها اللاجئون، فسجل إعجابه الشديد بحجم التنوع المهني والحرفي والاستثماري الذي يباشره المهاجرون، وتفاجأ بأن التجربة الأوغندية في استضافة اللاجئين، لم تكن من قبيل الحلول الطارئة أو المؤقتة، وإنما من نوعية الحلول المستدامة لمشكلة يعدها العالم من أكبر المشكلات التي تواجهه؛ حيث تبين أن المهاجرين في أوغندا يشكلون تكتلاً اقتصادياً واستثمارياً واعداً، تتجاوز فوائده ومنافعه الاقتصادية حدود التوقعات؛ إذ أنهم يعملون في قطاعات كبيرة من الاقتصاد الحاضن، في الزراعة والتجارة والنقل والخدمات وصناعة الذهب والأقمشة، بل إن الكثيرين منهم، يمتلكون فعلياً وحدات إنتاجية خاصة بهم كالمطاحن والمطاعم والمقاهي ومراكز بيع السلع والخضروات.
لقد استطاعت أوغندا في تجربتها الفريدة مع اللاجئين والمهاجرين، أن تقدم أنموذجاً مثالياً لإدارة 1.35 مليون لاجيء إفريقي، إدارة اقتصادية واستثمارية وحضارية وإنسانية في آن واحد، وكان مفتاح نجاحها، هو عدم اعتبار تدفق اللاجئين مشكلة معوقة لاقتصادها الوطني، بل فرصة مواتية لدعم هذا الاقتصاد وإنعاشه، ليس هذا فحسب، وإنما لرفد سلة الغذاء العالمية بصادرات اللاجئين من المنتجات والمحاصيل المزروعة بأيديهم، وكذلك بصادراتهم الصناعية المختلفة.
ورغم أن القوانين الأوغندية واجهت مشكلات دستورية منعت تجنيس هؤلاء اللاجئين وفق قانون 1999 الخاص بالمواطنة ومراقبة الهجرة، إلا أن إصرار الدولة على إنجاح التجربة، بعيداً عن تعقيدات السياسة ومصالح السياسيين الخاصة، كشف المبالغات الدولية بشأن قضايا الهجرة واللجوء، وأثبت بشكل عملي، إمكانية استثمار الطاقات البشرية للمهاجرين، وترويضها ترويضاً ناعماً خلاقاً، لتصبح قوة اقتصادية منتجة وداعمة للاقتصاد الحاضن، عوضاً عن اعتبارها قوة مستهلكة وعبئاً يستوجب الشكوى والضجر، ومن جهة أخرى، قدمت التجربة، درساً أخلاقياً وإنسانياً بالغ التأثير في التعامل الإنساني مع اللاجئ المهاجر، وكان قوام هذا الدرس، أن منطق الاحتواء والدمج الإيجابي الحقيقي للاجئين، أجدى إنسانياً في حق اللاجئ نفسه، وأجدى اقتصادياً في حق المجتمع الحاضن، وأولى في كل الأحوال، من منطق الإقصاء والتشكيك الذي يحلو استغلاله من قبل السياسيين في بريطانيا هذه الأيام.
وفي الختام، يتوجب على الحكومة البريطانية في ظل ما يسببه نقص العمالة من اختلالات صارخة في الاقتصاد الوطني، أن تعيد النظر مجدداً بشأن طريقة تعاطيها مع قضايا اللجوء والهجرة، وأن تفتش بجد واجتهاد، عن صياغة دستورية وقانونية جديدة، تمهد للمهاجرين أسس الدعم الاقتصادي الفاعل للناتج المحلي الإجمالي، وتتيح لهم فرص النهوض بالقطاعات الحيوية المنوط بها انتشال الاقتصاد من حالته المتأزمة، عبر استخراج الكنوز الكامنة من الموارد المتنوعة التي يحتوي عليها تراب المملكة المتحدة، وتجنب الاقتصاد خسائر مالية سنوية تقدر بحوالي 30 مليار جنيه استرليني(35 مليار دولار أمريكي) بسبب نقص العمالة، وتؤسس أيضاً، لمعالجات أكثر إنسانية لطاقات بشرية هجرت أوطانها بحثاً عن عالم جديد، فلم لا تكون قطاعات الإنتاج المختلفة في المدن والمناطق الإنجليزية هي العالم الجديد المأمول والمنشود لتلك الطاقات؟ إن تحقيق ذلك كله لن يكلف الحكومة البريطانية في (داونينج ستريت) شيئاً، اللهم إلا مجموعة من الأسئلة البسيطة، يتم توجيهها لجامعة أكسفورد عن معطيات التجرية الأوغندية وجدواها العميقة بالنسبة لمستقبل الاقتصاد في بريطانيا.

في صيف 2025: فعاليات استثمارية كبرى في لندن بتنظيم سعودي-بريطاني

التأمين الوطني في بريطانيا وخيبة الأمل

قانون الموت الرحيم والإجهاض يقسمان حزب العمال الحاكم

سحب المنتجات من الأسواق في بريطانيا: حقوقك وكيفية المطالبة بالتعويض

باريس سان جيرمان مهتم بنجم ريال مدريد

بريطانيا تنجو بنسبة 50% من رسوم ترامب على الصلب

موجة الحر تضرب بريطانيا.. وتحذيرات بإغلاق النوافذ لمدة يومين!

مستشفى نوتنغهام متهم بالقتل غير العمد، هل هذا صحيح؟

سباق جزيرة مان تي Man T في المملكة المتحدة