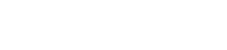مقالات
بريطانيا الحائرة بين أمجاد الماضي وإمكانيات الحاضر
نشر
منذ سنتينفي
1٬292 مشاهدة
By
Fatima
شكلت أزمة السويس عام 1956، العلامة الأولى على اضمحلال الإمبراطورية البريطانية، إذ تمكنت مصر، الدولة النامية، من إفشال المخطط البريطاني-الفرنسي بالسيطرة على قناة السويس عبر القوة العسكرية. لكن النهاية الرسمية للإمبراطورية البريطانية كانت عام 1997، عندما سلَّمت آخر مستعمراتها، هونغ كونغ، إلى الصين.
رغم ذلك، فإن تفكير العديد من قادة المجتمع البريطاني التقليدي، الذين يمثلهم حزب المحافظين، ظل متعلقا بالماضي وأمجاده، ولم يستوعب أن بريطانيا لم تعد إمبراطورية، وإنما دولة متوسطة القوة، هذا إذا أحسَنَت إدارة اقتصادها. وما يعزز هذا التفكير هو عضوية بريطانيا الدائمة في مجلس الأمن الدولي، وتزعمها لمجموعة دول الكومونويلث، إضافة إلى علاقاتها السياسية والثقافية والاقتصادية الوطيدة بالولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزلندا ودول أخرى.
إن محاولة القيادات البريطانية المتعاقبة الإبقاء على الدور البريطاني السابق في العالم، قد دفع بريطانيا إلى معارضة قيام التجمع الأوروبي منذ نشأته في الخمسينيات، على الرغم من حث الولايات المتحدة لها على الانضمام إليه، لكنها كانت تخشى التحالف الفرنسي الألماني، وتعتبر التجمع الأوروبي الملتف حولهما، مهدِّدا لنفوذها في أوروبا والعالم. وعندما فشلت في إعاقة تشكيله، أنشأت عام 1960 مجموعة أوروبية منافسة له، هي “المجموعة الأوروبية للتجارة الحرة”، ضمت كلا من النمسا والسويد والنرويج والدنمارك والبرتغال وسويسرا. غير أن تماسك هذه المجموعة كان ضعيفا، على العكس من المجموعة التي تقودها فرنسا وألمانيا، التي تسعى نحو الوحدة، ما أدى إلى اضمحلالها وحلها لاحقا.
بريطانيا عضواً في المجموعة الأوروبية
وفي أواخر الستينيات، عَدَلَت بريطانيا عن رأيها المعارض للتجمع الاوروبي، نتيجة لضغوط أميركية عليها، وبروز طبقة جديدة معتدلة في حزب المحافظين، بقيادة رئيس الوزراء، أدوارد هيث، تؤمن بالتعاون مع أوروبا. لكن فرنسا، بقيادة الجنرال شارل ديغول، وقفت حائلا دون انضمامها، إذ كان ديغول يرى بأن بريطانيا لن تكون عضوا مخلصا في الاتحاد الأوروبي، بل ستكون معرقلا للوحدة الأوروبية، وسوف تعمل كعين أمينة للولايات المتحدة داخل أوروبا. لم تكن نظرة ديغول خاطئة كليا، على الأقل في تلك الفترة، فعلاقة بريطانيا بأميركا تأريخية وعميقة.
لم تستطع بريطانيا أن تنضم إلى المجموعة الأوروبية إلا بعد استقالة ديغول عام 1969 وتولي جورج بومبيدو السلطة. وعندما صار أدوارد هيث رئيسا للوزراء عام 1970، تقدم بطلب العضوية وقد قبل الطلب، فصارت بريطانيا عضوا في يناير من عام 1973. لكنها ظلت عضوا قلقا طوال فترة عضويتها التي استمرت 47 عاما، وخصوصا في عهد مارغريت ثاتشر، التي قلصت من مساهمة بريطانيا المالية في المجموعة وسعت إلى الحصول على استثناءات عديدة من الأنظمة والقوانين الأوروبية.
وعندما انطلقت العملة الأوروبية الموحدة عام 1999، رفضت بريطانيا التخلي عن الإسترليني، ما أنذر بأنها لا تعتزم البقاء طويلا في الاتحاد، فكيف يمكن أن تكون عضوا في مجموعة تسعى نحو الوحدة، بينما ترفض تبني عملتها؟ كما ترفض السماح لمن يحمل الفيزا الأوروبية (شِنغِن) بدخول بريطانيا؟
لكن عددا متزايدا من أعضاء وقادة حزب المحافظين تغير تفكيرهم تجاه أوروبا، وصاروا يؤيدون التقارب معها، منهم جفري هاو وجون ميجور ومايكل هزلتاين وكنيث كلارك وديفيد كاميرون وتريزا مي، لكن عددا كبيرا من المحافظين ظلوا يعتقدون بأن بإمكان بريطانيا أن تحتفظ بدورها العالمي كقوة كبرى، وقد تمكنوا من إرغام ديفيد كاميرون على تحديد موعد لإجراء استفتاء عام حول البقاء في أوروبا، والذي كانت نتيجته لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
حملات مناهضة
كانت الحملة المناهضة للبقاء في الاتحاد شرسة وقد وظفت عامل التخويف من تزايد هجرة الأوروبيين الشرقيين إلى بريطانيا، واختلقت أكاذيب مثل “إن بريطانيا تدفع حاليا 350 مليون جنيه إسترليني أسبوعيا للاتحاد الأوروبي، وعندما تنسحب منه فإن هذه الأموال سوف تذهب لخدمة الصحة الوطنية”! كما روَّج قادة الحملة لاحتمالات هائلة لاتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة ودول الكومونويلث واليابان، وأن الانسحاب سيكون وفق اتفاقية تبقي الشراكة التجارية مع الاتحاد الأوروبي، وأن نيل بريطانيا “استقلالها وحريتها” سوف يفتح باب الازدهار والرخاء لأن بريطانيا تتمتع بعلاقات دولية واسعة، وأنها سوف تستفيد منها.
لكن الحقيقة مختلفة تماما. فحجم التبادل التجاري البريطاني مع أيرلندا، وهي من الدول متوسطة الحجم في الاتحاد الأوروبي، يفوق التبادل التجاري مع الهند واليابان وباكستان وبنغلادش مجتمعة! بينما يفوق التبادل التجاري مع ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة، التي تحتفظ بريطانيا بعلاقات خاصة معها.
الآمال التي كانت معقودة على “الحرية والاستقلال” اللذين سيأتيان بالسمن والعسل إلى بريطانيا، ويعيدان إليها دورها الريادي السابق في العالم، قد تلاشت، ولم يعد يؤمن بها سوى قلة من الذين يطلِق عليهم البريطانيون “ذوي عقلية الجزيرة الصغيرة”.
استطلاعات رأي
استطلاعات الرأي الأخيرة أشارت إلى أن نسبة المؤيدين لمغادرة الاتحاد الاوروبي قد تراجعت من 52% في استفتاء عام 2016، إلى 34% عام 2022، ولو أُجري الاستفتاء مرة أخرى، لصوت ثلثا الشعب البريطاني، إلى العودة إلى أوروبا!
إن تخبط سياسات حزب المحافظين الحاكم منذ عام 2010، والذي صار يخلع زعماءه بسهولة غير مألوفة، وانقسام الحزب انقساما حادا حول أوروبا، قد كلف بريطانيا غاليا، فلم تبقَ ضمن الاتحاد الأوروبي، شريكها التجاري الأكبر، إذ إن 60% من صادراتها تذهب إلى أسواقه، ولم يتحقق أي فتح تجاري مع الولايات المتحدة أو الكومونويلث أو اليابان، وكل التعاملات التجارية الحالية مع هذه الدول، كانت موجودة قبل مغادرة الاتحاد الاوروبي. ومنذ فوزه حتى الآن، تعاقب على زعامته خمس زعماء ورؤساء وزارات، اثنان منهم دون انتخابات عامة!
لكن حزب العمال المعارض هو الآخر كان منقسما انقساما حادا تحت قيادة اليساري المتشدد، جرمي كوربين، ولم يتمكن من توحيد صفوفه في ظل قيادة جديدة حتى عام 2020، عندما انتخب السير كيير ستارمر زعيما له. الاستطلاعات تشير إلى أن السير كيير سوف يفوز في الانتخابات المقبلة، لكن حزب المحافظين لن يدعو إلى انتخابات مبكرة قبل موعدها في يناير من عام 2025، ما يعني أن التخبط والضعف سوف يتواصلان، وربما يتفاقمان، على الرغم من كفاءة رئيس الوزراء الجديد، في إدارة الاقتصاد.
حزب العمال
حزب العمال لا يمتلك سياسة واضحة تجاه أوروبا، ويبدو، أن بريطانيا ستبقى خارج الاتحاد خلال الأمد المنظور، لأنه، لا الحكومة ولا المعارضة، تتبنى حاليا سياسة العودة إلى الاتحاد الأوروبي على الأمد القريب. ولا يمكن العودة إلى إلا عبر إجراء استفتاء جديد، ومثل هذه الاستفتاء لن يجريه حزب المحافظين.
هل كانت مشاكل بريطانيا كلها بسبب سياسات حزب المحافظين وحدها، أم أن هناك ظروفا عالمية ساهمت في إضعاف اقتصاد بريطانيا ونفوذها في العالم؟ لا شك أن هناك ظروفا دولية، بعضها غير متوقع، مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، قد أعاقت تبوء بريطانيا الموقع الذي يأمل به قادتها الحالمون، لكن انقسام حزب المحافظين خلال العقود الثلاثة الماضية، وعدم بروز زعامة قوية منذ استقالة مارغريت ثاتشر عام 1990، قد تسببا في إضعاف العلاقة بأوروبا، التي هي الشريك التجاري الأكبر لبريطانيا، والتي كان يمكنها أن تلعب دورا فاعلا فيها.
نقاط القوة
تمتلك بريطانيا العديد من نقاط القوة الاقتصادية، والتي يمكنها أن تلعب دورا مهما في النهوض الاقتصادي، إن استثمرت جيدا. أولى هذه النقاط هي نظامها التعليمي الناجح وجامعاتها المرموقة، وقدراتها العلمية الفائقة، وكون لندن مركزا ماليا عالميا، وكون اللغة الإنجليزية لغة عالمية، إضافة إلى جاذبيتها السياحية وبُناها الأساسية المتميزة التي يمكنها أن تكون مركزا عالميا للاتصالات واللقاءات الدولية.
كما أن عضوية بريطانيا الدائمة في مجلس الأمن، وحلف الناتو، ومجموعة الدول الصناعية السبع، ومجموعة العشرين، وقيادتها لمجموعة الكومونولث، وكونها قوة نووية، تعطيها أهمية استثنائية، لكن مثل هذه الأهمية تتطلب اقتصادا قويا يتحمل الإنفاق على الأمن والدفاع وتقديم المساعدات المالية للدول الأخرى.
من الأسلحة الأخرى التي امتلكتها بريطانيا سابقا، لكنها آخذة في التخلي عنها تدرجيا بسبب نقص الأموال، هو سلاح الإعلام. الخدمة العالمية في مؤسسة بي بي سي، مثلا، لعبت دورا كبيرا في الترويج لبريطانيا في العالم طوال 80 عاما، ودرء المعلومات التضليلية التي تبثها بعض الدول ضدها، لكن الإنفاق على هذه المؤسسة آخذ في التقلص باستمرار، ما يعني إغلاق المزيد من البرامج. تلفزيون بي بي سي العربي، الذي يخدم ما يقارب نصف مليار إنسان في العالمين العربي والإسلامي، سوف يُغلق آخر العام الجاري، بينما تمتلك روسيا قناة عربية، وكذلك تركيا، وتمتلك إيران عشرات القنوات التلفزيونية في اللغتين العربية والإنجليزية. السلاح الفاعل الآخر هو المساعدات المالية المقدمة لدول العالم الثالث، والتي خُفِّضَت أخيرا من 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 0.5 %.
طريقة جديدة للتعامل مع المجتمع الدولي
وزير الخارجية البريطانية الأسبق، ديفيد ميليباند، قال، وفق ما نشره تشاتام هاوس، “إن على بريطانيا أن تطور طريقة جديدة للتعامل مع المجتمع الدولي، طريقةً تتجنب كلا من إيهام النفس والانحدار”.
لا يمكن بريطانيا أن تكون دولة قادرة على الإيفاء بالتزاماتها الدولية، كعضو دائم في مجلس الأمن وعضو فاعل في حلف الناتو، وزعيمة لدول الكومونويلث، إن لم تتمكن من تعزيز نموها الاقتصادي وتوفير الأموال التي يتطلبها الدور العالمي الفاعل.
مغادرة الاتحاد الأوروبي، دون أن تكون هناك منافع واضحة، ألحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد البريطاني، وأضعف تماسك مكونات المملكة المتحدة. فأسكوتلندا الآن تسعى إلى الاستقلال، بينما أيرلندا الشمالية أصبحت فعليا جزءا من السوق الأوروبية، مع عدم وجود حدود بينها وبين أيرلندا الجنوبية. كما أن تغيير رئيس الوزراء ثلاث مرات خلال ثلاثة أشهر، إضافة إلى التخبط السياسي والاقتصادي، قد أضعف الثقة العالمية بالدولة البريطانية.
لا شك أن كثيرين من سياسيين وإداريين وخبراء وأكاديميين، بل وحتى من المحافظين المتشددين، يدركون الآن حجم المشكلة، ويؤمنون بأن الحل هو في تبني مقاربة واقعية للسياسة والاقتصاد والدور الدولي، وهي الاستثمار في المجالات الاقتصادية التي تمتلك فيها بريطانيا أفضلية، حينها ستتمكن من أن تلعب الدور الذي يلائم حجمها وقدراتها الاقتصادية.
الكاتب والباحث الأكاديمي العراقي، حميد الكفائي

تشابي ألونسو يريد “صفقة واحدة” للبداية مع ريال مدريد!

نادي ليفربول يتعرض لمأساة كروية بعد دهس مشجعين له وسط الاحتفالات

النساء ورياضة السيارات في المملكة المتحدة

هل أنت مؤهل لتلقي دعم مالي أو قسائم غذائية بقيمة 100 جنيه إسترليني؟

حرائق السيارات الكهربائية تسجل ارتفاعاً ملحوظاً في بريطانيا

روبيرت ليفاندوسكي يحسم مصيره مع برشلونة

أغلى موقع ساحلي في بريطانيا

قواعد جديدة في حدائق الحيوان البريطانية لتغيير آليات العمل والزيارة

طلاب جامعة هارفارد Harvard أمام مصير مجهول بعد قرار ترامب