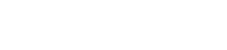السعودية
العلاقات الخارجية في المنظور السياسي حول رؤية السعودية 2030 .. مسارات انفتاح وتصفير عداوات!!
نشر
منذ سنتينفي
1٬738 مشاهدة
By
Baida
في بدايات انطلاق رؤية السعودية 2030، لم تكن الأبعاد والأهداف السياسية المتضمنة في بنودها الاستراتيجية، قد أصبحت بعدُ ماثلة بوضوح في الواقع السعودي المعيش، كما لم تكن الملامح الجوهرية للسياسة الخارجية على وجه الخصوص، قد أخذت شكلها المتطور الراهن من الرسوخ والاستقرار والفاعلية، ولعل السبب في ذلك هو غلبة الاهتمام بالإصلاح الاقتصادي على توجهات الرؤية، كأولوية متقدمة وضرورية لتحقيق التنوع في الموارد و النهوض بقطاعات الإنتاج، ومن ثم تحقيق أولويات أخرى شاملة وطويلة الأمد، واليوم، وبعد مرور أكثر من خمس سنوات على تلك البداية، أصبح واضحاً أن القيادة السياسية في المملكة تحصد النجاح تلو النجاح على مستويات عدة، أبرزها تصحيح المسارات الوطنية المعنية بإعادة صياغة العلاقات الخارجية والدبلوماسية بين الرياض وعواصم العالم، وهو ما تم عبر خطوات جادة وواثقة تناقشها السطور القادمة.
كتب: محسن حسن
خطوات تصحيح مسارات رؤية السعودية 2030
فيما يلي الخطوات الرئيسية لتصحيح مسارات رؤية المملكة العربية السعودية 2030:
شمولية الإصلاح وعمومية التغيير
أولى هذه الخطوات يتمثل في شمولية الإصلاح وعمومية التغيير؛ حيث حرص النهج الإصلاحي الذي تبنته رؤية 2030 بإشراف مباشر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على استبعاد الانتقائية والترقيع والاجتزاء من خطط التطوير، جنباً إلى جنب، مع الالتزام بنهوض متزامن ومتعاضد لكافة القطاعات المستهدفة، ودون إغفال لمعطيات الصورة الإيجابية الكاملة التي يجب أن تظهر عليها سياسات المملكة وعلاقاتها الخارجية في أعين الكبير والصغير والقريب والبعيد، بما في ذلك المواقف الدبلوماسية، والتي حظيت بدورها بإسهامات خلاقة من حيث التعديل وإعادة الصياغة وفق التطلعات الطموحة التي أولتها إياها القيادة السعودية، باعتبارها الواجهة العاكسة لصورة المملكة كشريك فاعل في القضايا الدولية والإقليمية، وكوسيط وازن ومعتدل في كافة نزاعات المنطقة والعالم، وقد كان هذا الإصلاح الاقتصادي الشامل، هو البوابة المثالية التي اعتمدتها المملكة لتعزيز حضورها السياسي، كما أنه ساهم في منح ذلك الحضور، وجهاً ديناميكياً وحركياً فاعلاً، قوامه استقلالية القرار، وتقليص الاعتمادية على الغير، إلى جانب الشراكة المتبادلة مع المجتمع الدولي ممثلاً في قواه المؤثرة والصاعدة،
الارتباط الاستهلالي الطوعي والتلقائي
وثانية الخطوات، شكَّلها الارتباط الاستهلالي الطوعي والتلقائي، بين إطلاق استراتيجية 2030 من جهة، وحضور ولي العهد السعودي، كطاقة شبابية طموحة ومتطلعة وكقائد بارز ومستقبلي ضمن المشهد العام للمملكة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، من جهة ثانية، وهو الأمر الذي جعل من نجاح الاستراتيجية نجاحاً موازياً لشخصية الأمير، كما جعل من نجاح الأمير، نجاحاً موازياً للاستراتيجية، وهذه التبادلية كانت محفزة ودافعة لقبول التحدي الإصلاحي الكبير والشامل الذي اعتمدته المملكة، وحققت من خلاله نجاحاً باهراً حتى اللحظة، فبنظرة متأنية، نجد أن ارتباط استراتيجية الإصلاح بطموح الأمير الشاب، منحها عنفوان الرغبة في التغيير، وفاعلية الدعم والتحفيز المستمدة من السمات الشخصية لولي العهد، والتي كانت مشمولة برغبة صادقة في استدعاء كل شبر من أرض المملكة إلى المشهد الدولي والعالمي، ليس على سبيل الحضور الشكلي والديكوري، وإنما ضمن وجود واقعي لافت للأعين ومحرك للركود وجاذب للاستثمارات، وقبل ذلك، ضامن لتصحيح الصور النمطية، والكلاشيهات المغلوطة حول جدارة السياسة المحلية الحاكمة في المملكة، وقدرتها على التفاعل الدولي والإقليمي مع المتغيرات، وهو ما استدعى بدوره رغبة سعودية عارمة في النهضة والتطوير، ظهرت بشكل جلي في صندوق سيادي للاستثمار قوامه أكثر من 650 مليار دولار، يستثمر القوى الناعمة وغير الناعمة للبلاد؛ في السياحة والسياحة الدينية، في الطاقة المتجددة، وفي الترفيه والرياضة والذكاء الاصطناعي، وكافة القطاعات غير النفطية، الأمر الذي خلق للقيادة السعودية مسارات انفتاح عديدة يمكن عبرها تأسيس علاقات خارجية إيجابية وغير مسبوقة مع دول العالم.
خلخلة الجمود المجتمعي السعودي تجاه الذات والآخر المختلف
أما ثالثة الخطوات، فقد تجسدت في خلخلة الجمود المجتمعي السعودي تجاه الذات والآخر المختلف، ففي الوقت الذي شاعت فيه ثقافة الانغلاق والتخويف من فتح باب الاحتكاك الحضاري والثقافي والاجتماعي ضمن شرائح المجتمع المحلي، وهو الوقت الذي كان العالم ينظر فيه إلى السياسة الحاكمة في المملكة باعتبارها سياسة تسلط وإهدار للحريات العامة والخاصة، انطلقت رؤية 2030 السياساتية الشاملة، لتعيد صياغة المجتمع المحافظ، وفق أسس وعلاقات جديدة، تتمسك بالجذور والثوابت والأصول، لكنها لا تمنع من مرونة كل ذلك في التعاطي الإيجابي مع ثقافات العالم وأنشطته الإنسانية والتراثية والشعبية، وكذلك مع الحقوق والمواثيق والأعراف الدولية، دون مساس بالهوية الوطنية والدينية الراسخة بين السعوديين، ومن ثم، فقد انعكست صورة عالمية جديدة للسياسات الشاملة داخل المملكة في أعين شعوب الدول وحكوماتها، وهي الصورة التي منحت هذه الحكومات وتلك الشعوب، بعداً إيجابياً آخر من أبعاد الشخصية السعودية المتدينة، لا باعتبارها شخصية صارمة ومتجهمة وعابسة متشددة، ولكن باعتبارها شخصية ودودة وقادرة على مجاراة الثقافات الفذة واحتواء الحضارات المبدعة والمتحررة، وقد جاءت إجراءات الحد من بعض سلطات الأجهزة والهيئات المحلية، كهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للتخفيف من أعباء التطبيق الصارم للرقابة المجتمعية والدينية، وللسماح بالمزيد من الحقوق الخاصة والعامة، فحصلت المرأة على حق قيادة السيارة، وعلى حق التنقل والسفر وممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهنية والوظيفية المختلفة، دون اشتراط ما يكبلها أو يحد من استقلاليتها وقدرتها على العطاء والإبداع.
وقد شكل هذا الانفتاح السعودي الجديد ضمن رؤية المملكة 2030، إطاراً تمهيدياً مواتياً للخطوة الرابعة، وهي شروع القيادة السياسية في بلورة وصياغة الملامح الجديدة للسياسات الخارجية والعلاقات الدولية، والتي كان من أهم علاماتها وأهدافها، حرص الرياض على إطلاق العديد من المبادرات الدبلوماسية الهادفة إلى تيسير سبل التلاقي مع دول الجوار، عبر (تصفير العداوات) وتنحية الخلافات، وتذليل كافة العقبات والتحديات التي تحول دون حل النزاعات البينية المتجذرة وطويلة الأمد مع هذه الدول داخل نطاق الشرق الأوسط وخارجه، ومن ثم، فقد تجلت آليات متنوعة لتحقيق ذلك، كان في مقدمتها توسيع مجالات التعاون والتشاور الاقتصادي والاستثماري مع الجوار الإقليمي، كإجراء ضروري لتهيئة الأجواء السياسية المساعدة على حل الخلافات العالقة مع جميع الأطراف، فاستضافت العاصمة السعودية قمماً عديدة لمجلس التعاون الخليجي، بخلاف استقبالها زيارات عديدة لقادة دول العالم، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية والصين وشخصيات أخرى من دول آسيا الوسطى، كما لعبت المملكة دوراً مؤثراً في الحوار الاستراتيجي بين دول الخليج وروسيا، وتمكنت كذلك من إنهاء الخلاف الخليجي مع قطر، ومن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران وسوريا مؤخراً، الأمر الذي مهد بدوره لترويض الأزمة مع الحوثيين في اليمن، وبالتالي منح الفرصة لاتخاذ خطوات جادة في تعزيز الأمن الإقليمي.
حصد إنجازات ثمينة على مستوى العلاقات الخارجية للسعودية
وقد مثل تعزيز الأمن الإقليمي، خطوة أخرى خامسة، ضمن الخطوات الدالة على نجاح رؤية 2030 في حصد إنجازات ثمينة على مستوى العلاقات الخارجية للمملكة العربية السعودية؛ حيث كانت القناعات الوطنية للرياض راسخة ومستقرة بخصوص ضرورة العمل الجاد على تهيئة حالة من الاستقرار والأمن المستدام في المنطقة، تدفع باتجاه الحفاظ على جهود التنمية والإصلاح، وتساعد على إخراج دول المنطقة وخاصة الدول الخليجية، من معادلة الاعتماد الحصري على واشنطن في تحقيق أمن الخليج، خاصة بعدما أصبحت الأخيرة تتخذ مسارات واضحة ومستقلة نحو الانسلاخ من المنطقة ومن قضاياها الشائكة، ما ظهرت معه حاجة المملكة الماسة للشروع في طروحات جديدة وغير مطروقة تستهدف خلق مناخ إقليمي ضامن لتحقيق أهدافها ومصالحها الجيوسياسية، وبالتالي وجدنا المخطط الاستراتيجي السعودي، يتجه ضمن أهداف الرؤية الوطنية، إلى تأسيس تحالفات تحقق ذلك المناخ الأمني المستدام، وتعزز أدوار السياسة الخارجية السعودية على مستوى الأمن الإقليمي والدولي، فتم تأسيس (مجلس البحر الأحمر) سنة 2020، إضافة لانخراط الرياض في منظمات الأمن الإقليمي الهجينة لقارة آسيا، عبر إبرام شراكة أمنية مع (منظمة شنغهاي) للتعاون خلال 2023، مع كل من الصين والهند وروسيا، إلى جانب سعي المملكة خلال العام القادم 2024، نحو الانضمام لمجموعة الاقتصادات الناشئة (بريكس) والتي تشمل البرازيل وجنوب أفريقيا مع باقي دول منظمة شنغهاي السابقة، وهو ما يعني أن الفترة الحالية، تشهد نهوضاً قوياً للسياسات الخارجية السعودية، ولكافة علاقاتها الدولية، بالشكل الأمثل، الذي يمكِّن صاحب القرار السيادي في البلاد، من تعزيز الدور الوطني في الاشتباك الفاعل مع القضايا الدولية والإقليمية، وهو ما تحقق فعلياً عبر وساطات الرياض المؤثرة في الملف الخليجي والسوداني والأوكراني، وفي ملفات أخرى عديدة.
تغيير وجه السياسة الخارجية السعودية نحو الأفضل
وبصفة عامة، فقد بات واضحاً أن التلاحم بين خطط واستراتيجيات 2030 الإصلاحية من جهة، والطموح الشخصي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان من جهة ثانية، يلعب دوراً محورياً في تغيير وجه السياسة الخارجية السعودية نحو الأفضل، ولعل ما تشهده الأوساط العالمية والدولية من سجالات مؤيدة أو معارضة للمفردات والعناصر التطبيقية المرتبطة بهذا التلاحم، يمثل دليلاً صريحاً وعملياً، ليس على خروج السعوديين من عزلتهم ومحليتهم فحسب، وإنما أيضاً على نجاح السياسة الخارجية للبلاد وفق مستويات عدة، انطلاقاً من نجاح السياسات الداخلية كذلك، الأمر الذي يجب أن يُلقي بمسؤولية أكبر من حيث التخطيط والإنجاز مستقبلاً، حيث تبقى ضرورة أن يستفيد المخطط السعودي من بعض أخطاء الماضي والحاضر، أمراَ حتمياً، خاصة مع ما تحققه مستويات الترقي والانتقال النهضوي في المملكة من زيادة في وتيرة الاحتكاك الواقعي والعملي مع أنماط قوية وراصدة واختبارية من العلاقات الدولية والإقليمية، وهو ما يقتضي أن يتم التأسيس للمرحلة القادمة، وفق تعزيز المصداقية التطبيقية والميدانية القائمة على نقد الذات والاعتراف بالإخفاق حال حدوثه، واتخاذ مسارات أكثر عمقاً وبعداً عن الديكورية الخادعة والانفتاح الكاذب، وفي كل الأحوال، سيتعين على السياسات الخارجية السعودية أن تظل متجددة، وقادرة على خلق سجالات مباشرة وفاعلة وعملية، فيما يتعلق أولاً، بقضايا النزاع العالقة مع دول الجوار، وثانياً، فيما يخص الوصول إلى مستويات فائقة من السيادة الوطنية المبنية على تعزيز الانتماء ودعم العدالة ونزاهة المواقف والقضايا، وثالثاً، فيما يخص ثوابت الأمة العربية والإسلامية، وهي الثوابت التي تستدعي تواجداً سعودياً خلاقاً في الملفات المصيرية كملف القضية الفلسطينية ومبادرة السلام العربية 2002 مثلاً، ورابعاً، فيما يتعلق بحجم التنافس الإقليمي، فإنه يتعين أن تنتهج المملكة في قادم الأيام نهجاً عملياً براجماتياً فيما يخص مصالحها الاقتصادية والإصلاحية، بالتزامن مع تحييد الخلافات الناشئة عن ذلك التنافس، وإطفاء جذوتها كلما لاحت أو تأججت، وهو ما يتطلب تركيزاً شديداً على استهداف الربح وتجنب الخسارة، وأخيراً، لابد من توظيف القوى الناعمة السعودية ضمن نطاق التطوير الحادث في السياسات الخارجية والعلاقات الدولية، ولكن مع ذلك، يجب الحذر من إشكاليات الملفات الحقوقية، والتعامل معها بمنطق الاحتواء الذكي والفعال، ودون التورط في قرارات خاسرة، يمكن للغرماء استغلالها.
وبعد، إن أفضل ما تمخضت عنه خلاصات المنظور السياسي لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 حتى اللحظة، هو التأسيس المستقبلي لتوجه سعودي وطني نحو مسارات انفتاح مستدامة مع المحيطين الإقليمي والدولي ضمن سياسات خارجية معززة للسيادة والأمن الإقليمي، وممهدة لحالة جيوسياسية خادمة للمصالح والأهداف الاستراتيجية المستقلة، وفي مقدمتها تصفير العداوات وجذب المزيد من الموارد والاستثمارات.

التأمين الوطني في بريطانيا وخيبة الأمل

قانون الموت الرحيم والإجهاض يقسمان حزب العمال الحاكم

سحب المنتجات من الأسواق في بريطانيا: حقوقك وكيفية المطالبة بالتعويض

باريس سان جيرمان مهتم بنجم ريال مدريد

بريطانيا تنجو بنسبة 50% من رسوم ترامب على الصلب

موجة الحر تضرب بريطانيا.. وتحذيرات بإغلاق النوافذ لمدة يومين!

مستشفى نوتنغهام متهم بالقتل غير العمد، هل هذا صحيح؟

سباق جزيرة مان تي Man T في المملكة المتحدة

الخرافات الرياضية التي يؤمن بها لاعبو كرة القدم: وهم أم حقيقة!